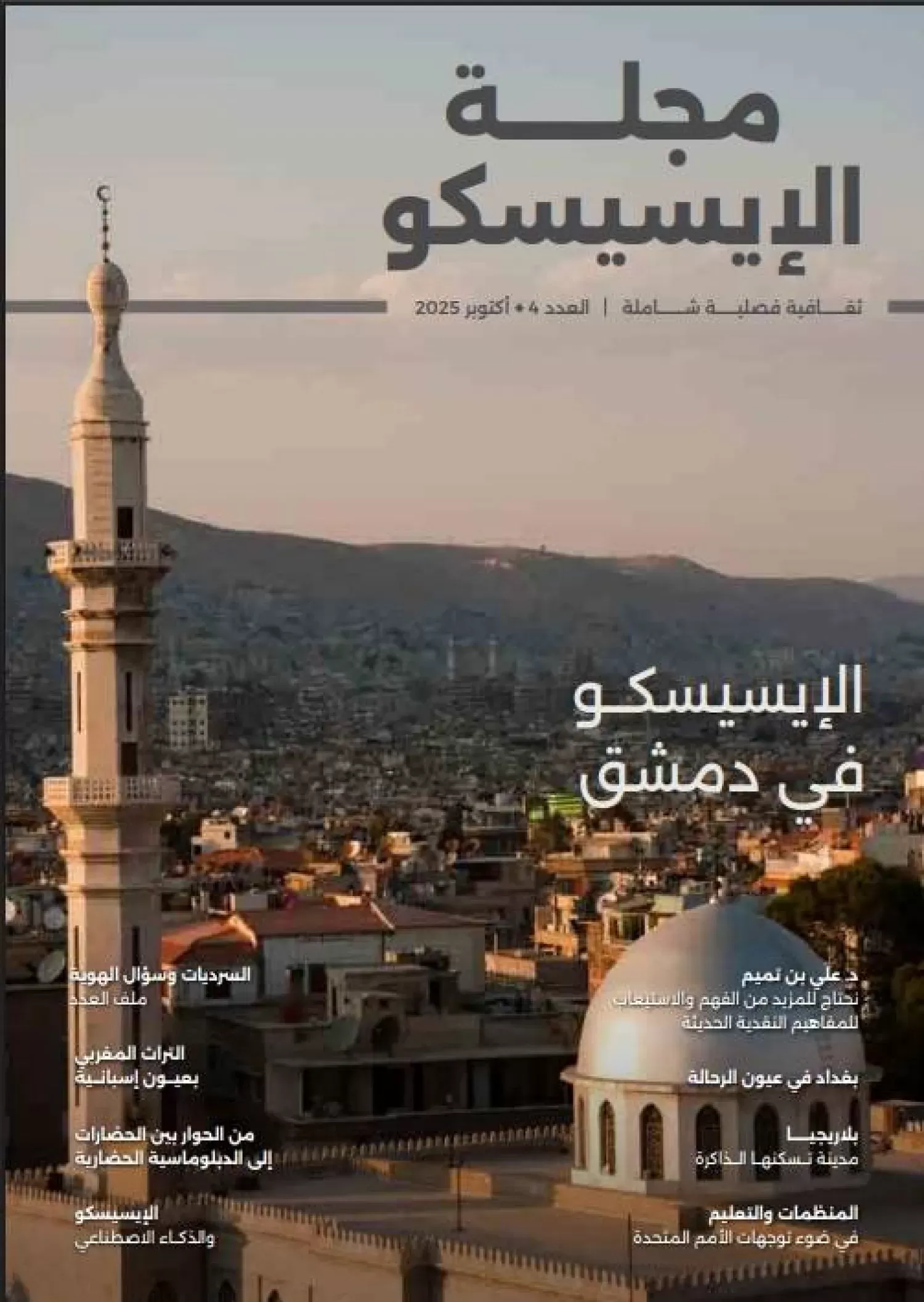«عمى الذاكرة» لحميد الرقيمي سيرة إنسان مزّقت الحرب جذوره
«عمى الذاكرة» لحميد الرقيمي سيرة إنسان مزّقت الحرب جذوره
عمر شهريار
في روايته «عمى الذاكرة»، يكتب الروائي اليمني الشاب حميد الرقيمي سيرة إنسان أفقدته الحروب، بما تخلفه من دمار، تاريخه وهويته الذاتية، وانمحت ذاكرته من فرط قسوة أصوات الرصاص، ومشاهد الأشلاء والجثث، ورائحة الموت في كل مكان حوله، وملمس ركام البنايات والبيوت التي تساقطت عليه ونام وسط حطامها وأطلالها. إن الحرب كانت تحاصره من كل حواسه، يسمعها ويبصرها ويشمها، ويلمس آثارها الكارثية، حتى أفقدته وجوده، لكنه كالعنقاء يقف ثانية من بين الرماد والأطلال، ليشاهد موت جميع من حوله، وكأنه شاهد على مأساة شعب تمزقت جذوره.
الرواية الصادرة عن «دار جدل»، وفازت منذ أيام بجائزة «كتارا» لأفضل رواية منشورة، تصور أثر الحروب على الإنسان، في كل مكان وزمان، وتتخذ من الإنسان اليمني والحروب التي شهدتها بلاده تمثيلاً جمالياً، من خلال نموذج إنسان طامح إلى حياة هادئة وبسيطة، وحب يملأ عليه حياته، لكن قدره جعله يعاني طوال عقود من حروب متعاقبة، لا يعرف أطرافها، ولا من يشعلها ولا من يستفيد منها، لكنه في النهاية يكون الضحية الدائمة لأطراف متصارعة على جثته.
تدور أحداث الرواية حول شخصية «بدر»، الراوي البطل، الذي يستخدم تقنية أقرب إلى كتابة السيرة الذاتية، سيرة هذا الراوي، الذي أذاقته حرب سابقة، وهو في الخامسة من عمره، مرارة فقد الأب والأم والعائلة كلها، وبقي هو شاهداً على موتهم الفاجع، وجثامينهم التي رآها ممزقة، هذه الحوادث الرهيبة التي أسقطتها ذاكرته تماماً، في رد فعلي نفسي لطفل في عمره لم تستوعب روحه هذه الفجيعة، وعثر عليه شيخ عجوز بين الجثث، فأخذه وأسماه «يحيى»، مدعياً أنه حفيده من ابنه «سالم»، وانتقل به إلى قرية نائية بعيداً عن نيران الحروب ليحافظ على الطفل الذي نجا بأعجوبة، ولم يعرف الطفل بتلك الأحداث وحقيقة هويته سوى في مطلع الشباب، وقبل رحيل «جده» واعترافه له بحقيقة ما جرى له في طفولته، لتكون الصدمة الأولى التي يعيها، ويبدأ معها في استعادة الذاكرة عبر مقاطع بعيدة وغائمة، في رحلة حياته الجديدة، بعد انتقاله للعاصمة صنعاء، محاولاً صناعة مستقبل مغاير لما مضى، ونسج هوية جديدة يصنعها بنفسه واختياره، ويبدأ دراسته الجامعية للقانون، ويقع في حب زميلته «يافا»، لكن تداهمه حرب جديدة، تفقده كل من أحبهم وأحبوه، كأنه منذور للحرب، ومشاهدة موت أحبته.
البطل نموذج للبطل الضد، المفعول به دائماً، ليس بسبب عيب أو ضعف في شخصيته، لكن لأن الحروب وأقدراها وقسوتها أقوى منه، تنفخ فيه نيرانها فيستحيل ورقة شجر جففها البارود، ويطوحها صوت القنابل في الهواء، هذه القنابل التي كانت تقابلها قنابل أخرى داخله، وتعتمل في روحه، وتظل دوماً على وشك الانفجار، وهي قنابل التساؤلات الوجودية الكبرى عن المصير والماضي وقدر الإنسان، وماهية الحرب، عن الموت والفقد، وحياته التي تفقد كل يوم مغزاها ومعناها، فلماذا لا يموت هو، ويظل شاهداً على الموت، هذا القدر الذي يلازمه حتى نهاية الرواية، فيصير كأنه شاهد قبر.
يخوض بدر رحلة وجودية شائكة ومأساوية، وبالتوازي معها يخوض رحلة مكانية للهرب من الموت المجاني بقنبلة لا يعرف من ألقاها عليه، فيلتقي مجموعة من الشباب الذين جمعتهم مأساة الحرب ولكل منهم فجيعته الخاصة، يخططون للهرب إلى إيطاليا، طمعاً في الفرار من جحيم الحرب إلى جنة الغرب الموعودة، فيهربون من صنعاء إلى عدن، أو ما تبقى منها بعد أن دمرتها الحرب، ومن عدن يسافرون إلى القاهرة، ثم إلى السودان، ومنها عبر الصحراء الشاسعة إلى ليبيا، ثم في مركب هجرة غير شرعية إلى إيطاليا. وفي كل بلد ومدينة يستقرون عدة أيام، ويقدم الراوي وصفاً لهذه الأماكن، ومن فيها، ثقافتها وناسها، وتصوراته السابقة عنها، ومدى تشابهها أو اختلافها عن موطنه وجذوره في اليمن بقراها وجبالها، واصفاً حال اليمنيين في الشتات، وأماكن تجمعهم بخاصة في القاهرة.
برغم قسوة الأحداث المفعمة بالدماء والفقد، والموت سواء تحت القصف، أو غرقاً في البحر، أو عطشاً في الصحارى، فإن الكاتب اعتمد طوال السرد على قدر من اللغة الشعرية، وتصوير كثير من الشخصيات تصويراً شعرياً، أو الاهتمام بوصف الطبيعة وجمالها الباذخ، فهذه الطبيعة كانت ملاذ البطل التي يناجيها ويلتحف بوجودها، وكانت بطلاً مساعداً ومعيناً له، إلى جوار الأبطال المساعدين الذين ترسلهم له الأقدار في كل مرحلة من حياته، بدءاً من الجد وسالم ولطيفة في الطفولة، مروراً بحبيبته يافا وصديقه عيد حمادي في صنعاء، وصولاً إلى لطفي ومحمد وطه وياسر، ثم عوض في رحلة الهروب والهجرة، وانتهاء بالطبيبة النفسية التي يبكي بين يديها، عقب إنقاذه وحده، وموت كل رفاقه في رحلة الهجرة غير الشرعية، ليولد هو من جديد، ربما باسم ثالث وهوية جديدة.
الرواية زاخرة بمجموعة من العلامات، بدءاً من العنوان الدال على فقدان البصيرة والهوية والتاريخ الشخصي، ثم الإهداء الطويل نسبياً: «إلى كل من طالتهم نيران الحرب، إلى ضحايا البحار والصحارى، إلى المنفيين والمشردين ومن فقدوا ذواتهم في رحلة البحث عن الحياة»، ويختتمه بجملة لافتة «هذه سيرة أبطال، ومرافعة في وجه الظلم، وحكاية قابلة للحدوث في أي زمان ومكان».
وعقب الإهداء، ثمة تصدير شعري لافت بمقطع من قصيدة للشاعر اليمني عبد العزيز المقالح، بما يتواشج مع أزمة البحث عن هوية ضائعة، فيبدو هذا التصدير محاولة للتجذر، للتذكرة بأن هنا كان تاريخ وشعر وأدب وجذور، فضلاً عن كون الشعر نفسه يتصل بطبيعة شعرية اللغة الطاغية على الرواية كلها.
ثمة ملمح تقني أخير يجب الإشارة إليه، فرغم أن السرد كله بضمير المتكلم، فإن الراوي البطل ينزع إلى كسر الحائط الرابع بينه وبين جمهور القراء الضمنيين، مخاطباً قارئه في أحد مواضع الرواية، قائلاً: «لعلك قرأت الكثير من المآسي، واستطاع الراوي أن يحفر وجدانك في مشاهد المدن المدمرة والقرى الخائفة والمباني المتساقطة، لكنني غير قادر على أن أرسم مشهداً واحداً، ولا أجد عليه جثة مرمية في العراء (...) عليك أن تعي هذا، وقبل أن تأخذك هذه الصفحات المنقطة بالسواد، تذكر أن من يكتب سيرته هنا كان إنساناً طبيعياً مثلك. لا أعلم بأي زمن تقرأني، ولا على أي أرض تراقب هذا السير المتعب، لكنني على علم بأننا نتشابه كثيراً، حتى وإن كان للحرب رأي آخر».